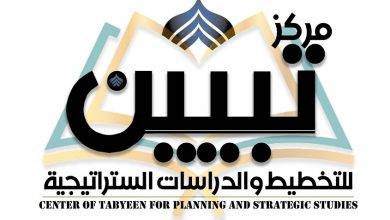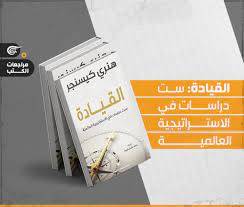دور التربية في مكافحة الارهاب وآثاره النفسية
إعداد : أ.د حيدر محسن الشّويليّ - كلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة ذي قار

مستخلص البحث
ظهر الإرهاب في العراق ليكون مشكلة أمنية وتربوية واجتماعية وكثير من المشاكل الاخرى اذ لها مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة لم يسبق لها مثيل ، ومما زاد من خطورة هذه المشكلة نظرة بعض القائمين بتلك الأعمال الإرهابية على أن أفعالهم بطولية ، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي تتركها على المجتمع بكل قطاعاته ، وتعنى التربية برفع درجة وعي الفرد في مختلف الأعمار وفي شتى الظروف والملابسات وتنمية السلوك الإنساني وتغييره وتطويره حتى تتكون لديه المواطنة الصالحة في مجتمعه .
وفي ظل الظروف الراهنة والأحداث المتوالية انتشرت المفاهيم الخاطئة بين جماعات تتعارض مع الفهم الصحيح للقيم والإسلام والجنوح إلى التطرف والمبالغة فكراً وممارسة وإثارة نفوس الشباب وتعبئتها ضد الدولة وعلماء الدين .
فضلاً عن ذلك فإن أي مجتمع إنساني بناءه وثقافته التي يتميز بها عن غيره من المجتمعات ، وله تركيبه السياسي والاقتصادي ، وله عقيدته وتراثه وقيمه التي ينشأ حولها فكره وتفكيره وله عاداته وتقاليده ومُثُله العليا التي ينبثق منها توجهاته الفكرية وانتماءاته العقائدية .
لذلك نجد أن المجتمع حينما يصوغ أهدافه ومبادئه فإنه يسعى جاهداً لأن تكون هذه الأصول متلائمة مع عقيدة المجتمع وفكره والقيم التي يؤمن بها فتعمل على إعداد الإنسان في إطاره الاجتماعي بواسطة الأهداف والغايات التي تحددها الفلسفة العامة للمجتمع والمبادئ الأساسية التي يؤمن بها الأمة والمعتقدات التي يعتنقها أفرادها بعد ان سادت متغيرات عديدة شكلت العالم المعاصر .
وفي ضوء ما سبق هناك تضع التربية اساسها في تربية الاجيال وتكون موضحة لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يقع الفرد ضحية لتلك الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تضر بالمسلمين وغيرهم اعتقاداً منهم أن ذلك هو طريق الصواب . كما توضح للناس نهج القرآن الكريم التي تعتمد في أساليب الدعوة على الحكمة والموعظة الحسنة ومخاطبة الناس بالأسلوب المناسب لهم.
في غمرة التحولات الإنسانية الجديدة وفي نسق التغيرات الاجتماعية العاصفة في عصر الصدمات الحضارية تأخذ التربية بأساليبها المتنوعة أهمية بالغة الجدة والخطورة ففي زمن الذي بدأت فيه الأمم والشعوب تتلمس مخاطر وجود الارهاب وتلملم أطراف هويتها إزاء عصف التغيرات العلمية الجديدة بدأت التربية تطل بدورها الجديد كصمام أمن وأمان بمنح الأمم قدرة متجددة على بناء هويتها والمحافظة على وجودها.
وقد أُختير موضوع البحث تحسّساً بأهميته التي تخدم وخدمت المجتمع ، و يأتي ذلك لتقديم أكثر من منحنى مما يخدم مسيرة الأمة الاسلامية .
الفصل الأول
التعريف بالبحث
مشكلة البحث :
ان إيمان الباحث بالمجال التربوي هو دافع أسمى إلى إجراء مثل هذا البحث ، فالمجتمع بشكل عام يتطلب الالتزام بمحددات تربوية ودساتير ولوائح قيمة ينطلق منها العاملون فى ممارستهم المختلفة ، وفى إطار التقدم الهائل في مجالات التطبيق فإنه – أي المجتمع- أحوج ما يكون إلى تلك المحددات التي تدعم صواب ما يقرره وما يفعله كل فرد عامل بها ، في ظل الظروف الراهنة والأحداث المتوالية وانتشار المفاهيم الخاطئة بين جماعات تتعارض مع الفهم الصحيح للقيم والإسلام والجنوح إلى التطرف والمبالغة فكراً وممارسة وإثارة نفوس الشباب وتعبئتها ضد الدولة وعلماء الدين.
وقد ساهمت التربية وبدت معالمها واضحة في المجتمع العراقي ضد تنظيم داعش الارهابي في سد الطريق امام كارثة كادت تحل بالعراق والمنطقة بصورة عامة .
وفي ضوء ما سبق جاء البحث الحالي لتسليط الضوء على اشـــراقــــات دور التربية لما لها – أي التربية- من دور مهم في حياة الفرد والمجتمع ، كما لعبت دوراً مهماً في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي ، وساعدت في إعطاء المجتمع وحدته .
ومن هنا تبرز مشكلة البحث الرئيسة من طريق الاجابة عن التساؤل الآتي : ما دور التربية في مكافحة الارهاب وآثاره النفسية ؟.
ويتفرع من هذه المشكلة عدة اسئلة فرعية تستحق المناقشة :
* ما مدى أهمية التربية في مكافحة الارهاب وآثاره النفسية ؟
* ما مدى غرس تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة والقيم المعتدلة لحماية الشباب من الإرهاب ؟
أهمية البحث :
يرى الباحث ان التربية كانت ولا تزال منهجاً حياتياً متكاملاً ، منطلقاً من قوله تعالى : { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } ([1]) .
ولقد استلهمت التربية واستمدت قواعدها من أصول القرآن الكريم ، لتزويد الانسان بمبادئ الدين والقيم الأخلاقية السامية ، ويعدّ النبي محمد ( صل الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام) المثل الأعلى للإنسان في أخلاقه وسلوكه وفيما يتحلى به من محاسن الصفات والخصال ويشهد على ذلك قوله تعالى : ( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) ([2]) . وفي قوله تعالى : ( ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ) ([3])
والحيادية في التربية مطلوبة في بلد مثل العراق ، وعليه تكرس جميع المواد الإعلامية والتعليمية بقوة لصالح العقيدة الإسلامية ونشرها وتثبيتها في نفوس أفرادها وهذا هو ما يدعونا إليه الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة دون مبالغة أو تطرف، فالإسلام هو دين المحبة والرحمة – واستخدام القوة والعنف من قبل بعض الجماعات لإحداث التغيير ليس هناك أي سبب مقنع لها، وهؤلاء الأفراد هم من أبناء هذا المجتمع نشؤوا في ظل ظروف معينة وتربية أسرية كان لها الأثر الكثير في هذه السلوكيات.
فضلاً عن ذلك فإن المجتمعات بحاجة الى منظومة تربية تستند إليها ، عندما تقوم بالتفاعل الايجابي، بعضها مع بعض ، إذ تستطيع هذه القيم أن تكفل قيم المجتمع وأهدافه ، ويعتمد ذلك على مدى قبول المجتمعات لمثل هذه القيم أو رفضها إذ ان قبولهم يؤدي فيما بعد الى وحدة بناء المجتمع أو تماسكه .
فالاهتمام بفئة الشباب في المجتمع، والانشغال ، بقضايا الشباب يعبر عن الاهتمام بمستقبل المجتمع الإنساني ككل ، كما أن مرحلة الشباب لا تقل خطورة وتأثيراً في التنشئة الاجتماعية الكلية للإنسان عن مرحلة الطفولة المبكرة ، وتعد مرحلة الشباب أكثر مراحل العمر تأثيراً بالتغيرات السريعة التي تطرح اختيارات عديدة فيما يتعلق بالالتزام بالحاضر والمستقبل (محمد ،1985،ص5). ويعد الشباب طاقة متجددة ، فهم أدوات الحاضر وأهم طاقاته وقدراته . والشباب هم العنصر الرئيس في بناء المستقبل، وعلى عاتقهم ستواجه التحديات المستقبلية ، وعليهم يتوقف نجاح المجتمعات وتطورها في حسن استثمار وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم بعدِّهم رأس مال بشري للمساهمة في نهضة المجتمع وتقدمه . وقد تجلى ذلك عندما هبّ الكثير من الشباب العراقي عندما سمعوا فتوى (الجهاد الكفائي) تلبية لها وايماناً منهم بحماية العراق من دنس الارهاب والتكفير .
ومن الجدير بالذكر ومن الطبيعي أن تتعدد العطاءات ومنهج الدعوة للإيمان والإصلاح والتكامل الإنساني . فقد جاءت التربية موضحة لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يقع الفرد ضحية لتلك الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تضر بالمسلمين وغيرهم اعتقادا منهم أن ذلك هو طريق الصواب .
ولكن هنا برز دور التربية التي توضح للناس نهج القرآن الكريم التي تعتمد في أساليب الدعوة على الحكمة والموعظة الحسنة ومخاطبة الناس بالأسلوب المناسب لهم . وفيما يتعلق بالتربية فإنها تهتم بتعليم أفراد المجتمع من جيل الصغار – وعن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي سواء أكان ذلك عن طريق الأسرة أو المدرسة – كيف يسلكون في المواقف الاجتماعية المختلفة على أساس ما يتوقعه منهم المجتمع .
وتعنى التربية كذلك بالسلوك الإنساني وتنميته وتطويره وتغيره أي أن هدفها أن تنقل أفراد الأجيال الصغرى المهارات والمعتقدات والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة التي تجعل منهم مواطنين صالحين في مجتمعهم متكيفين مع الجماعة التي يعيشون فيها. بناء عليه فإن التربية هي عملية تعليم وتعلم الأنماط المتوقعة من السلوك الإنساني. وبناء عليه فالتربية هي نظام اجتماعي يحدد الأثر الفعال للأسرة والمدرسة في تنمية النشء من النواحي الجسمية والعقلية والأخلاقية حتى يمكنه أن يحيا حياة سوية في البيئة التي يعيش فيها، فالتربية أوسع مدى من التعليم الذي يمثل المراحل المختلفة التي يمر بها المتعلم ليرقى بمستواه في المعرفة .
إذن فالتربية هي عملية عامة لتكييف الفرد ليتمشى ويتلاءم مع تيار الحضارة الذي يعيش فيه، ولهذا تصبح التربية عملية خارجية يقوم بها المجتمع لتنشئة الأفراد ليجاروا المستوى الحضاري العام.
وتأتي هذه الدراسة في وقت حاولت فيه أن تثري الدراسات المناظرة بصيغة أو أخرى، وتقدم نتائج يمكن مقارنتها مع نتائج تلك الدراسات. ومن هنا برزت أهمية هذا البحث في كونه يركز على دور التربية وأهميتها في حماية الأبناء والمجتمع من الإرهاب. فهناك حكم نسبي في النظر إلى تلك الأعمال العنيفة والقائمين عليها. فالإرهابي في نظر بعضهم مناضل من أجل الحرية والدين، وفي نظر بعضهم الآخر مجرم.
وبناءاً على ما تقدم فقد تناول الباحث في هذا البحث موضوعاً يعتقد بأهميته القصوى في ظل التأثيرات المتنامية مما دفع بالباحث للقيام بهذا البحث ، وتكمن أهمية البحث الحالي في النقاط التالية :
- أنه تناول أهمية التربية لدى المجتمع ، لما لها من دور محوري في صياغة مستقبل العراق وقيمه ، والاعداد للحياة بأبعادها المختلفة.
- أن هذا البحث يحاول أن يبرز أهمية الموضوع من حيث انعكاساته على قيم المجتمع في ظل المستجدات المتسارعة من حوله: العالم الجديد ، العولمة والغزو الثقافي .
- يسعى البحث الحالي للوصول إلى مقترحات وتوصيات ، لكي يتمكن المجتمع من مواكبة المستجدات الحادثة ، والحفاظ على هويته الحقيقية في ذات الوقت.
- في ضوء ما سبق فإنه من المؤمل بأن يشكل هذا البحث خطوة على طريق تقدم المجتمع العراقي ويستفيد منها كل مطلع مهتم بشؤون المجتمع .
تحديد المصطلحات
تعريف التربية :
- هي تعلم مهارات أساسية ولازمة لاستمرار المجتمع وتكون الوراثة دافعاً للتفكير والعمل الخلاق الذي يعد بدوره ضرورياً للتغير الثقافي، في الوقت الذي يكون فيه تغير الثقافة دافعا لمزيد من التجديد والتغير. ( غيث،1988،ص152)
- هي عملية التكيف والتفاعل بين الفرد والبيئة التي يعيش فيها .( القيسي وآخرون،1993،ص12)
تعريف الارهاب (Terrorism)
- بالبحث عن المعنى اللغوي لكلمة “إرهاب” في اللغة العربية، نجد أنها كلمة من أرهبه أي أخافه، أقرها المجمع اللغوي من الفعل “رهب” أي خاف، وفزع والإرهابيون لفظ يطلق على الذين يسلكون سبل العنف والقوة لتحقيق أهدافهم ( المعجم الوجيز،1990،ص 32)
- تطلق كلمة “إرهاب” للدلالة على أي فعل يتضمن إحداث خلل في الوظائف العامة للمجتمع، وينطوي تحتها ألوان متعددة من العنف ابتداء من عمليات اختطاف الطائرات في الفضاء إلى إلقاء القنابل بلا تمييز، إلى عمليات الاختطاف ذات الطابع السياسي، والاغتيال، وحوادث القتل باسم الدين وإتلاف الملكيات العامة، أي أنه تهديد باستعمال عنف غير عادي لتحقيق غاياته السياسية والدينية، ويستخدم في إحداث تأثير معنوي أكثر منه مادي ( موريس،1991،ص53) .
- عرفت وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (CIA) : الإرهاب هو التهديد باستعمال العنف لأغراض سياسية من قبل أفراد أو جماعات، بهدف إحـداث صدمة أو فزع أو ذهول أو رعب لدى الفئة المستهدفة والتي تتعدى الضحايا المباشرين للعمل الإرهابي (التل، 1998،ص 23)
- الإرهاب هو العنف المنظم بمختلف أشكاله أو حتى التهديد باستخدامه والموجه لدول ما أو مجموعة من الدول أو جماعة سياسية أو عقائدية على يد جماعات لها طابع تنظيمي بهدف محدد هو إحداث حالة من التهديد والفوضى لتحقيق السيطرة على هذا المجتمع أو التقليل من هيبة القائمين عليه. ( دعبس، 1994، 9)
الفصـل الثانــي
جوانب نظــــــرية
التربية :
لاشك أن الرسالات الالهية تهتم وتهدف إلى صنع مجتمع انساني متكامل يقوم على اسس صحيحة وسليمة تتجاوب وتتسق مع فطرته التي فطر الله تعالى الناس عليها، تضمن له حياة طيبة خيّرة في عالم التزاحم الدنيوي، وحياة خالدة منعمة في العالم الاخروي. فالتعاليم الدينية إنما جاءت لتنظم حياة الانسان في جميع مفرداتها واختلاف اصعدتها، فهي تنظم من جهةٍ علاقته برّبة مربيةً فيه روح العبودية الحقة لله تعالى المحررة له من كل أشكال العبوديات الاخرى، وذلك من خلال العبادات المفروضة ومبدأ الطاعة والتسليم المطلق لأحكام الله وقضائه والانقياد التام لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) وخلفائه المنصوص عليهم، لتنسجم حركة الفرد والمجتمع ـ من خلال حركات افراده في نظام يكمل بعضه بعضاً، فتتوحد وجهة الامة وتسير وفق الغاية الالهية. وإذا كانت دروس التربية تشمل التوعية العلمية المبسطة لجميع الأبعاد المختلفة المؤثرة في حياة الأسرة المعاصرة والتي تؤثر بالتالي في تنمية المجتمع خصوصاً وأن الأسرة المعاصرة تعيش في عالم متغير محاط بموجات متتالية من التغيرات على المستوى المحلي والعالمي، هذه التغيرات والمتغيرات يتأثر بها الفرد في الأسرة مهما كان البعد المكاني عن مركز التغيرات بعد اتساع شبكة الاتصالات ، فيعيش الفرد الآن في قرية صغيرة وهذا يتطلب منه أن يعرف من هو وطبيعة دوره المتغير وكيف يستطيع أن يحيى خلال الصراع الأبدي بين قوى الشر والخير، كيف يبحث عن قوت يومه بعيدا عن الصراع المستمر الذي يؤثر في صحته النفسية. ( دعبس، 1988،ص117).
ويرى الباحثان اننا مدعوون لمعرفة تأثير التربية في الاسرة وذلك من طريق معرفة أهميتها ودورها .
اهمية الاسرة :
- الأسرة هي المكان الوحيد في مرحلة المهد وما بعدها بقليل للتربية المقصودة ولا تستطيع أي مؤسسة أخرى تقريبا أن تقوم بهذا الدور فهي تعلم الطفل اللغة وتكسبه بدايات مهارات التعبير الأسرة هي المكان الذي يزود الأطفال ببدور العواطف والاتجاهات اللازمة للحياة في المجتمع .
- تنشا الأسرة الروابط الاجتماعية الأسرية والعائلية للطفل والتي تكون بدايات العواطف والاتجاهات الاجتماعية لحياة الطفل وتفاعله مع الآخرين .
- الأسرة هي الوعاء التربوي الذي تتشكل داخله شخصية الطفل تشكيلا فرديا واجتماعيا.وهي بهذا تمارس عمليات تربوية هادفة لتحقيق نمو الفرد والمجتمع (سرحان،1981،ص 181)
- الأسرة أكثر دوما وأثقل وزنا من باقي المؤسسات المؤثرة على الطفل، وأكثر أهمية تأثيرها من تأثير الجيران والأقارب والأقران وحتى المعلمين.
- إن التفاعل بين الأسرة والطفل يكون مكثفا وأطول زمنيا من الجهات الأخرى المتفاعلة مع الطفل
- الأسرة هي الجماعة المرجعية التي يعتمد عليها الطفل عند تقييمه لسلوكه.
- تعتبر الأسرة في كافة المجتمعات الإنسانية من أكثر الجماعات الأولية تماسكا ولذلك تؤدي إلى نمو الألفة والمحبة والشعور بالانتماء بين أعضائها (الخميسي،2000 ، ص 184).
دور الأسرة المسلمة في الحفاظ على الأبناء:
إن الأسرة المسلمة تحافظ على أبنائها من خلال أسس اختيار الزوجة الصالحة، وتستمر المحافظة على فطرتهم من خلال ما تقوم به الأسرة عند استقبال المولود ومنها الآذان في أذن المولود ،ويستحب الآذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في أذنه اليسرى والحكمة من ذلك ما يلي :
- أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان الآذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته (عمر، 2007،ص37)
- التأكيد على الميثاق الذي أخذه الله من عباده بأنه الواحد الأحد ، ” وبهذه السنة يحفظ المولود عند أول خروجه إلى الحياة من الشيطان ، ويقع في نفسه التوحيد الموافق للفطرة المركوز فيه أصلا ذلك خير له عند كبره وبلوغه بإذن الله (مرسي ، 1997،ص55)
- مسئولية الأسرة في المحافظة على فطرة المولود ،”إن مشروعية الآذان في أذن المولود ، إشارة للأبوين إلى أن التربية يجب أن ينشأ عليها الأولاد تؤسس على كلمة التوحيد وهدى القرآن .( مرسي ،1997،ص56)
دور الاعلام الاسلامي في الحفاظ على الأبناء :
لابد من وجود إعلام إسلامي بديل عن ما هو موجود على الساحة ، من خلاله يمكن المحافظة على فطرة أبنائنا كما خلقها الله ويعرف الإعلام الإسلامي بأنه ” تكوين رأي صائب، يدرك الحقائق الدينية ويفهمها ويتأثر بها ، في معتقداته وعبادته ومعاملاته ، من خلال الكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المشاهدة لحماية الأجيال المسلمة من الانحراف والفساد ، ويتم ذلك من خلال ما يلي :
إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية، تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وإنتاج رسوم متحركة للأطفال تزرع في نفوسهم حب الإسلام والاعتزاز به. وإعداد برامج يقوم بتقديمها أطفال ،لصناعة جيل جريء في قول الحق . وإعداد حلقات تاريخية تلفزيونية عن شخصيات إسلامية كان لها تأثير في التاريخ الإسلامي .وإعداد برامج ترفيهية ، اجتماعية ، اقتصادية تهم أفراد المجتمع من منظور إسلامي. ونشر الثقافة الإسلامية عبر عدة برامج تهتم بالقرآن الكريم وبسير التابعين ، وبالأخلاق الحميدة .ولابد أن يكون للمرأة نصيب في ذلك من خلال إعداد برامج تخصها ويكون كل ذلك من منظور إسلامي. ( المرصفي، 1983،ص83)
مفهوم التربية الإسلامية:
يمكن تعريف التربية الإسلامية بأنها ” العملية المقصودة التي تستهدف المحافظة على فطرة الإنسان وإعداد شخصيته بجميع أبعادها منذ ولادته حتى وفاته وفقا لأحكام الإسلام وتوجيهاته” ( الهندي،2000،ص21).
خصائص التربية الإسلامية:
أ- ربانية المصدر: أي أن أسس وأصول وأحكام التربية الإسلامية من عند الله ويقصد بربانية المصدر “المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى أهدافه وغايته ،منهج رباني خالص لأن مصدره وحي الله تعالى إلى خاتم رسله محمد صلى الله عليه واله وسلم ( القرضاوي ،1985،ص36) لأن الله خالق الإنسان وهو أعلم بما ينفعه، فوضع هذا المنهج الرباني ليقوم حياته، ويصوب أفكاره وسلوكه.
ب– ثابتة الأسس: تتميز التربية الإسلامية بأن أسسها ثابتة، لأن مصدرها ثابت غير خاضع للتحريف والتغيير والتبديل، فهي تجمع بين الثبات والتغير، فالثبات يكون في العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق والنظم، وليس معنى ذلك أنها تتصف بالجمود بل هناك مرونة في الوسائل والأساليب” وحينما تتصف بالثبات، فإن لذلك مردوداً كبيراً ينعكس على العملية التربوية برمتها، إذ ينصرف جهد القائمين عليها ، نحو تطوير وسائلها و أساليبها واستراتيجياتها في ضوء أصولها الثابتة مما يوفر الوقت والجهد ويقيهم من التخبط والتردد والحيرة أمام السيل الجارف من الفلسفات والاتجاهات التربوية المتباينة في عالمنا المعاصر ( أبو دف ،2001،ص21)
ج– الشمول: تتصف التربية الإسلامية بالشمول، لأنها تشمل الإنسان والكون والحياة وكذلك لأنها تهتم بجميع جوانب شخصية الإنسان ، وشملت في طياتها جميع أنواع المعرفة سواء كانت دينية أو دنيوية . ومن مظاهر الشمول التي تميزت بها :-
– شاملة لكل الناس إلى قيام الساعة ، قال تعالى((” قُلْ يَا أَيُّها الناَّسُ إنِّي رَسُولُ اللهَّ إلِيْكُم جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلُك السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إلِهَ إلِا هُوَ يُحييِ وَيُمِيتُ فَآمِنوُا بِاللهَّ وَرَسُولِهِ الَّنبِيِّ الِّأميِّ الَّذِي يُؤْمِنُ باِللهَّ وَكَلمِاتهِ وَاتَّبعِوُه لَعَّلكُمْ تَهَتدُونَ” )) ( الأعراف : 158)
– شمول التربية الإسلامية لجميع مراحل حياة الإنسان حيث وضعت نظاماً لحياة الإنسان وهو في بطن أمه جنيناً، ثم عندما يكون طفلاً، ثم لما يبلغ ويتزوج، ثم عندما يكون أباً أو أماً، ثم لما يكون شيخاً كبيراً.
– التربية الإسلامية تنظم حياة الإنسان كلها في نفسه وعلاقاته مع غيره ،في بيته وعمله وفي كل أحواله ، فكل حياة الإنسان تكفل الإسلام بوضع منهج متكامل لها ،وجعل الالتزام بهذا المنهج عبادة يثاب عليها إذا خلصت النية لله عزو جل ( العياصرة ،2010،ص453)
د –التكامل: إن تميز التربية الإسلامية بالتكامل يتسق مع تميزها بالشمول “ويقصد بالتكامل أمران هما:
– تكامل ميادين التربية الإسلامية دون أن تقتصر على مكان دون مكان: فهي تتم في المدرسة والمسجد والشارع والنادي وميدان القتال وفي كل مكان .
– خلو التربية من التجزؤ، وعدم اقتصارها بالتالي على جانب واحد من جوانب شخصية الإنسان ، فالتربية الإسلامية ترفض النظرة الثنائية إلى الطبيعة الإنسانية التي تقوم على التمييز بين العقل والجسم أو على سمو العقل على الجسم ( العناني ،2001،ص17) .
ه–الإيجابية: إن شعور الإنسان المسلم بأنه مخلوق مكرم استخلفه الله لعمارة الأرض ، يدفعه هذا إلى الفاعلية والإقدام على العمل ،واستغلال كل طاقاته وقدراته، فالايجابية :” تتأتى من خلال المزج بين طاقاته كلها وربطها بعضها ببعض، فيتحول الكائن البشري إلى طاقة ايجابية عاملة في واقع الحياة ولكنها الايجابية السوية التي لا تتنكب الطريق كما أنها موجهة نحو الخير . (قطب ، 1981 ،ص30)
و– التوازن: إن الدين الإسلامي دين وسط بين الأديان السابقة قال تعالى(( وَكَذَلكِ جَعَلْناَكُم أُّمةً وَسطاً لِّتكَوُنوا شُهَدَاء عَلَى الناَّسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا )) ( البقرة : 143)
أن التوازن يرادف التوسط والاعتدال ويمكن تعريف التوازن في التربية الإسلامية بأنه ” التزام الاعتدال في تربية جميع جوانب المتعلم وعدم مجاوزتها بالزيادة التي تؤدي إلى الإفراط ، ويكون التوازن في التربية : النقصان الذي يؤول إلى الإهمال والتفريط ( أبو دف،2002،ص24)
يقول (الخطيب و الزيادي،2000، ص17) موضحاً هذا المعنى”: التوازن، وهو معنى واسع يشمل كل نشاط الإنسان توازن بين طاقة الجسم وطاقة العمل وطاقةالروح، توازن بين ماديات الإنسان ومعنوياته، وتوازن بين الحياة في الواقع والحياة في الخيال.وتوازن بين الإيمان بالواقع المحسوس والإيمان بالغيب، وتوازن بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية.
ي– الإنسانية(الانسجام مع الفطرة الإنسانية) : تتسم التربية الإسلامية بالنزعة الإنسانية، لأن الإسلام دين عالمي لم يفرق بين أسود وأبيض ولا عربي و أعجمي، ومعيار التمييز التقوى والعمل الصالح ، وجاء الإسلام بمبادئ وقيم صالحة لكل البشر ولكل زمان ومكان ، قال تعالى(( ” يَا أَيُّها الناَّسُ إنِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوًبا وَقَبائلِ لتِعَارَفُوا إنِّ أَكْرَمَكْم عِنْدَ اللهَّ أَتْقَاكُمْ)) ( الحجرات : 13)
” جاءت التربية الإسلامية منسجمة مع فطرة الإنسان ، كيف لا وهي تربية ربانية أبدعها خالق الإنسان؛ من هنا نجدها تلبي حاجات الإنسان المنسجمة مع الفطرة وشريعة الإسلام وكل عباداتها ومعاملاتها تعتني بجانب الإنسان ولأجل مصلحته، فالزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، والصلاة الصوم و تعينان الإنسان في حياته (العياصرة ،2010، ص524)
ويرى الباحثان ان الإرهاب ظهر في العراق ليكون مشكلة أمنية وتربوية واجتماعية لها مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة لم يسبق لها مثيل ، ومما زاد من خطورة هذه المشكلة نظرة بعض القائمين بتلك الأعمال الإرهابية على أن أفعالهم بطولية ، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي تتركها على المجتمع بكل قطاعاته ، وتعنى التربية برفع درجة وعي الفرد في مختلف الأعمار وفي شتى الظروف والملابسات وتنمية السلوك الإنساني وتغييره وتطويره حتى تتكون لديه المواطنة الصالحة في مجتمعه وفي ظل الظروف الراهنة والأحداث المتوالية انتشرت المفاهيم الخاطئة بين جماعات تتعارض مع الفهم الصحيح للقيم والإسلام والجنوح إلى التطرف والمبالغة فكراً وممارسة وإثارة نفوس الشباب وتعبئتها ضد الدولة وعلماء الدين .
وبناءاً على ما تقدم يرى الباحثان إن ما يحققه الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي من إنتصارات هي نتيجة إيمانهم بقضيتهم التي يحاربون من أجلها وغايتهم هي إرضاء الله سبحانه وتعالى وإرضاء ضمائرهم في تأدية واجباتهم تجاه بلدهم العراق العظيم . اذ إن هذا الجمع المبارك يضم الشيخ والشاب والعالم والمدرس والطالب والعامل ومن جميع الطوائف وبالآخر فهو يضم كل عراقي غيور وشريف ذهب ليدافع عن أرضه وعرضه ومقدسات . “لذا يجب على الجميع الدفاع عن العراق من موقعه في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية وكذلك إسكات الثرثارين وأصحاب الشائعات الذين يحاولون إحباط معنويات العراقيين ، في معارك شعبنا مع قوى الظلام التي بدأت بالرد على هجمات داعش الظلامية الوهابية . والانتصار الكبير الذي كسر ظهر الارهاب كان بمشاركة فعالة وكبيرة في كل ذلك كانوا جسد واحد وعقل واحد واتجاه واحد انهما يشكلان جيش العراق الواحد الموحد .
الإرهاب وأسبابه :
إذا أمعنا النظر في التراث النظري لمشكلة البحث وجدناه قد برز في محاور معينة لها أكبر الأثر في تشكيل الشخصية واتجاهاته حيث أيدت الكثير من الدراسات على أهمية تلك العوامل. وقد حرص الباحث على تناول التراث النظري بمنظور نقدي يقوم على الموضوعية والتحليل العلمي وسوف يعرض تلك الموضوعات على النحو الآتي وفي إيجاز شديد نعرض لتلك الموضوعات على النحو الآتي:
1.الأسباب الفكرية للإرهاب والعنف والتطرف
1- معاناة العالم الإسلامي اليوم من انقسامات فكرية حادة، بين تيارات مختلفة. ومرجع هذه المعاناة وما ترتب عنها من مشكلات وانقسامات هو الجهل بالدين والبعد عن التمسك بتوجيهات الإسلام، ومن أبرز التيارات المعاصرة، هي:
أ- تيار علماني: يدعو إلى بناء الحياة على أساس دنيوي وغير مرتبط بالأصول الشرعية ولا بالتقاليد والعادات والموروثات الاجتماعية الأصيلة، هي من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه، عوائق في طريق التقدم والانطلاق نحو الحضارة.
ب- تيار ديني متطرف: يعارض المدنية الحديثة وكل ما يتصل بالتقدم الحضاري، فهي من وجهة نظرهم ليست إلا فسادا في الأخلاق، وتفككا في الأسر وجمودا في العلاقات الاجتماعية، فهم يرون أن الحضارة تجعل الفرد يعيش لنفسه ملبيا لرغباتها متنكرا للآداب والفضيلة. ولذا فكل جانب يرفض فكر الآخر ويقاومه، وينظر إليه نظرة ريب وشك دون تمحيص وتقويم، ليصل إلى الحق والمبادئ الأساسية فيها، ليقارنها بما عنده من أصول ومبادئ يمكن أن تكون مشتركاً يجمع بينها ويكون فيه الخير. ( الظاهري: 2002، 61 – 62 )
2- تشويه صورة الإسلام والمسلمين: إن دين الإسلام هو دين العدالة والكرامة والسماحة والحكمة والوسطية، وهو دين رعاية المصالح ودرء للمفاسد. وإن أفعال الناس المنتسبين إلى الدين، تنسب عادة إلى الدين ذاته، فإذا غلا امرؤ في دينه فشدد على نفسه وعلى الناس، وجار في الحكم على الخلق، نسب الناس ذلك إلى دينه فصار فعله ذريعة للقدح في الدين. وإن الغلو في الدين في العصر الحديث شوه الدين الإسلامي الحنيف، ونفر الناس منه، وفتح الأبواب للطعن فيه، فتجرأ أناس على أفعال وأقوال لم يكونوا ليجرءوا عليها لولا وجود الغلو والغلاة، فسمع الطاعنون في الشريعة .( اللويحق: 1998، 693 )
2.الأسباب الاقتصادية للإرهاب والعنف والتطرف
– عدم القدرة على إقامة تعاون دولي جدي من قبل الأمم المتحدة، وحسم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للدول. ويكون ذلك عن طريق النمو، والتقليل من الهوة السحيقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وتحقيق مستوى حياة أفضل للغالبية العظمى من الشعوب بكرامة وشرف.
2- عدم قدرة المنظمة على إيجاد تنظيم عادل ودائم لعدد من المشكلات الدولية. مثل اغتصاب الأراضي والنهب والاضطهاد وهي حالة كثير من الشعوب. ( الظاهري: 2002، 57 – 58 ).
3.الأسباب السياسية للإرهاب والعنف والتطرف
1- التناقض الفاضح بين ما تحض عليه مواثيق النظام السياسي الدولي من مبادئ وما تدعو إليه من قيم إنسانية ومثاليات سياسية رفيعة، وبين ما تنم عنه سلوكياته الفعلية والتي ترقى به إلى مستوى التنكر العام لكل تلك القيم والمثاليات. هذا التناقض مدعاة لظهور بعض الممارسات الإرهابية الدولية كصرخة احتجاج مدوية على ما يحمله هذا التناقض الصارخ بين القول والفعل من معان.
2- افتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم في الرد على المخالفات والانتهاكات التي تتعرض لها مواثيقه بعقوبات دولية شاملة ورادعة ضد هذا المظهر الأخير من مظاهر العبث. إن التسيب الدولي هو الذي يفتح المجال واسعا أمام أخطبوط الإرهاب الدولي الذي يجمع في صفوفه بين القتلة والمحترفين والمرتزقة المأجورين وغيرهم من المغرر بهم دينيا أو سياسيا أو عقائديا، وتشجيعه على التمادي في احتقار القانون الدولي، والاعتداء على سيادة الدول والإساءة إلى حقوقها ومصالحها المشروعة بوسائل تدينها الأخلاقيات والأعراف الدولية كالتهديد والتشهير والابتزاز والقتل واختطاف الطائرات وتعذيب الرهائن من المدنيين العزل الأبرياء. إن هذا التخاذل الدولي في رأي أصحاب هذا التفسير قد ينتهي بكارثة دولية لا حدود لها. ( منصور، والشربيني: 2003، 244 – 245 ).
4.الأسباب الاجتماعية للإرهاب والعنف والتطرف
1.عدم الحكم بما أنزل الله في كثير من البلاد الإسلامية: من واجب الأمة كلها: أن تسلم بدين الله وتحكم شرعه سبحانه وتعالى وعند تتبع مظاهر الغلو العقدية أو العملية في كثير من البلاد العربية – على مر التاريخ – نجد غالبها يرجع إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا الانحراف العقدي أنتج انحرافاً عقدياً.
2.الفساد العقدي: الأصل أن الدين الإسلامي واحد، وقد تركنا الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولكن أقواما سلكوا سبل الأمم السابقة فتفرقوا في دينهم.
3 – اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم: إن قيام أمور حياة الناس الدينية والدنيوية معتمد – بعد الله – على وجود الآمر الناهي المنظم لشؤون الأمة وأمورها. ومن كمال هذا الدين أنه ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لأن من شأن ضبط هذه العلاقة انضباط أمور الأمة، وسيرها في حياتها على السواء.
4.عدم تكوين روح التعلق بالمجتمع الإسلامي أو بالأمة الإسلامية: وهذه الروح ضرورية للفرد للعيش في الحياة الاجتماعية ولدوامها.
5.غياب دور العلماء وانشغالهم: إن للعلماء منزلة عظيمة في المجتمع المسلم فهم ورثة الأنبياء كما أخبرنا بذلك رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأن غياب أثر العلماء أو انشغالهم يعرض المجتمع للهلاك .
6 .التفكك الأسري والاجتماعي: وهذا الحال تشهدها عديد من البلاد الأجنبية وعدد من البلاد العربية مما يؤدي إلى انتشار الأمراض النفسية ونسبة المجرمين والمنحرفين والشواذ.
5.الأسباب النفسية للإرهاب والعنف والتطرف
1 – الدوافع التدميرية النفسية المتأصلة :هناك من يرى من علماء النفس التحليليين أن ذلك يرجع إلى غريزة الموت والميل التدميري ( العدواني ) الذي هو ميل متأصل ضارب الجذور في تكوين البشر منذ خلقه الله تعالى ومن أولئك: ( فرويد، وميلاني كلاين ). ( منصور والشربيني: 2003، 249 ).
2 – ضعف الأنا العليا ( النفس اللوامة أو العقل والضمير ) وسيطرة الذات الدنيا ( ” الهوى” أو النفس الأمارة بالسوء، على الشخصية الإنسانية: فيتصرف الشخص في هذه الحالة وفق هواه أو الإيحاءات الخارجية الصادرة ممن يعتقد أنهم رمز للقوة والحرية والمثل الأعلى له وتتكون هذه الشخصية عادة لدى الأشخاص الذين يشعرون بالنقص في ذواتهم، ولدى من تعرضوا لتربية والدية أو أسرية قاسية أو لدى الأشخاص الذين لم يحققوا ذواتهم ولم يجدوا من يأخذ بأيديهم أو يحتويهم .( الحسين: 2002، 397 ).
3 . تضخم الأنا العليا بسبب الشعور المتواصل بوخز الضمير: وهذا من الحيل النفسية الدفاعية التي يلجأ إليها الشخص لتطهير ذاته والتكفير عن تقصيره تجاه نفسه أو معتقده الديني أو مجتمعه وغالبا ما يقترن ذلك بالخجل والاشمئزاز من النفس والاكتئاب ويبلغ في مرضى الوسواس والاكتئاب النفسي حدا من القسوة والخطورة ما يجعل الحياة جحيما من العذاب وعبثا لا يطاق، هنا تستحوذ على الشخص حاجة ملحة لانتقاد نفسه والسعي إلى إنقاذها من الهلاك أو الشعور بالخطيئة والعمل وفق ما يرضى عنه ضميره. هذا نوع من قلق ( الأنا ) إزاء ( الأنا الأعلى ).. كأن الأنا الضمير المتجهم لا يطيب له أن تطيب لنا الحياة.
( راجح: 1985، 574 )
4.الإحباط في تحقيق بعض الأهداف أو الرغبات أو الوصول إلى المكانة المنشودة: فقد يأخذ الإحباط لدى بعض الشباب صورة الشعور بالاكتئاب، وهناك من يتمرد ويظهر السلوك العدواني أو المتطرف نتيجة شعور الفرد بالهزيمة أو الفشل.
5 – هذاءات العظمة: تعد هذاءات العظمة عاملا نفسيا آخر، يمكن أن ييسر التورط في عنف أو حرب مدمرة، ويؤدي إليها. فهذاءات العظمة هو عرض مرضي عقلي، ويعني اعتقادا يسود فكر المريض بأنه شخص عظيم، دون أن يسند هذا الاعتقاد واقع يدعمه .( منصور، والشربيني: 2003، 247- 284 ).
6 – هذاءات الاضطهاد: تعد هذاءات الاضطهاد من أعراض المرض العقلي، ويمكن أن يحفز الرئيس أو القائد المضطرب إلى بدء حرب أو شن إرهاب أو عمل إرهابي، أو إلى تفضيلها. ففي هذا يعتقد القائد في دعاوى زائفة بأن الآخرين يكيدون للإضرار به، أو تدميره هو، أو بلده الذي يحكمه ويقوده، أو إلى فكره أو منطقه أو قيمه التي يؤمن بها، ولذا فإنه يصبح متشككا ويفضل أن يأخذ موقف الهجوم .
( منصور والشربيني – المرجع السابق: 384 )
7 – الشخصيات المتبلدة أو الفصامية: الشخصية المتبلدة أو الفصامية هي العامل النفسي المهم والأخير من العوامل النفسية لظهور العنف والإرهاب والتطرف وهذه الشخصية تمثل حالة مرضية تجعل صاحبها منفصلا عن الواقع، مخطئا في تقدير ظروفه، خاليا من المشاعر، وغير مكترث بشيء ( أي غير مبال ).
( منصور والشربيني، مرجع سابق، 248 – 249 )
6.الأسباب التربوية للعنف والإرهاب والتطرف
1 – نقص الثقافة الدينية في المناهج التعليمية من الابتدائي وحتى الجامعة في معظم البلاد الإسلامية.
فما يدرس في مراحل التعليم الأساس، لا يؤهل شخصا مثقفا بثقافة مناسبة من الناحية الإسلامية، ليعرف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو الحد الأدنى للثقافة الإسلامية ،وعدم تلبيتها لحاجات الطلاب في توعيتهم في أمور دينهم وتنوير فكرهم بما يواجههم من تحديات في هذا العصر؛ إلى نقص الوعي الديني بوجه عام مما يكون له الأثر السلبي على سلوك واتجاهات الأفراد ( الظاهري: 2002، 60 – 61 )
2 – عدم الاهتمام الكافي بإبراز محاسن الدين الإسلامي والأخلاق الإسلامية التي يحث عليها الدين: ومما يحث عليه الدين الإسلامي ويدعو إليه الرفق، والتسامح، وحب الآخرين ومراعاة حقوق المسلمين منهم وغير المسلمين، والسلام، والتعاون، والرحمة، والبعد عن الظلم والاعتداء والبعد عن الحكم بالأهواء الشخصية، وغير ذلك مما يدعم الأمن والحب والعدالة بالمجتمعات ولاسيما الإسلامية فالإسلام هو دين السلام والعدل والحرية. ولا بد من إظهار هذه المحاسن والأخلاقيات منذ بداية التعليم في الصفوف الأولى مع التركيز عليها في الصفوف الثانوية وبداية الجامعي.
3 – عدم الخضوع للنظام في مرحلة الطفولة في مختلف المراحل التربوية: والسبب في ذلك إهمال تدريب الإرادة بممارسة أعمال الضبط في ظروف الثورة والهيجان النفسي وبمقاومة الرغبات النفسية الشهوية ولا شك أن للإنسان نوازع وانفعالات سلبية لا بد من التحكم فيها وضبطها كالغضب، والشح والبخل عند الضيق والحاجة، والانتقام عند القوة والانتصار، وغيرها. ولهذا كله فإن بعض الأحداث الاجتماعية تحدث نتيجة عدم تكوين مثل هذه الروح الخاضعة للنظام. ( يالجن: 1987، 53 – 54 ).
الفصل الثالث
نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
قد يمر الانسان أحياناً بظرف معين مما يكون عبئاً على الشخص وعائلته لما تتميز به من اضطراب العواطف وعدم الاستقرار النفسي، وبالتالي التوتر في العلاقة الأسرية، وعلى الرغم من ذلك يبقى الأبناء يكنون كل الاحترام والمودة للوالدين، ويبقى السؤال لماذا يعاني بعض الأبناء ؟
- بسبب الصراع النفسي نتيجة التناقض ما بين مظهرهم الجسماني الكامل وخبرتهم القصيرة في الحياة الاجتماعية وتحملهم المسؤولية كراشدين، يكون هذا مصدراً لمعاناتهم النفسية والعاطفية لذلك يحتاج الأبناء في هذه المرحلة إلى التوجيه والإرشاد المتواصل من قبل الوالدين.
- يسعى البعض إلى الانفصال الجزئي عن جو العائلة والسعي وراء علاقات صداقة مع آخرين بمثل أعمارهم لقضاء وقت أكثر خارج المحيط العائلي، الأمر الذي يسبب قلقاً من قبل الوالدين على الأبناء .
- قد ينجرف البعض بتجربة مواقف جديدة ربما تعرضهم إلى مشكلات أو مواقف صعبة يكتشفون بعدها بأنهم قليلو الخبرة وينعكس هذا سلباً على ثقتهم بأنفسهم مما يولد لديهم شعوراً سلبياً تجاه قدراتهم على تحمل المسؤولية. ويبدأ باكتشاف ذاته أولاً واكتشاف ما حوله والتعلم من الآخرين ثانياً .
- يسعى البعض بصورة عامة وراء كل شيء جديد ونحو الانبهار بغض النظر عن نوعه وفائدته، ونتائجه ولذلك ننصح الوالدين خلال هذه المرحلة من اكتشاف ابنهم للذات والمحيط الخارجي أن يوجه الأبناء إلى مهارات ونشاطات مسلية ومفيدة نفسياً وجسمانياً ومن دون التعرض لأية خطر كالانتماء إلى النوادي الرياضية والثقافية والدينية أو أي نشاط يتطلب جهداً فكرياً أو جسمانياً.
- يؤدي الانزلاق في سلوك معين كالتدخين أو استعمال المخدرات والكحول أو قضاء الوقت بصورة غير مثمرة أو غير مفيدة، إلخ. يحدث هذا دائماً نتيجة الصحبة السيئة ودائماً يكون هذا السلوك جزءاً من سلوك سيئ لجماعة من الأفراد وليس ظاهرة انفرادية.
- يشكل اضطراب سلوك الابن أكثر خطورة عندما يكون كظاهرة انفرادية يجب على الوالدين حينها التنبه إلى هذه الظاهرة والتعامل معها بصورة صحيحة. لقد تبين من خلال التعامل مع كثير من حالات اضطراب السلوك عند المراهقين ان الأبناء يكونون بعيدين كل البعد عن رقابة الوالدين مما يسبب ذلك خطراً كبيراً لهم.
وفي ضوء ما تقدم يرى الباحثان ان المجتمع الإسلامي يتميز بالقيم والفضائل السمحة التي تحلى بها من خلال ارتباطه بالقيم الروحية والتقاليد الدينية ، وهي التي تحكم حياتنا وتوجه سلوكنا وتكسبنا ما نحن عليه اليوم من تماسك وتعاون وتوحد في الفكر والعمل ، والانثربولوجيا مهمتها الأساسية هي تمكين الإنسان من فهم نفسه عن طريق فهم مجتمعه حيث يجعلنا أكثر وعيا بالوحدة الأساسية للإنسان مما يسمح لنا أن نقدر ونفهم بعضنا البعض. وفي هذا البحث حاولنا أن نحدد بعضاً من الجوانب التربوية التي نتميز بها والتي نعيشها اليوم رغم كل الظروف والتي ساهمت بدفع حركة الحياة للمحافظة على شخصية الأمة ووقوفها أمام التحدي والتذويب .
وقد دل ذلك على مفهوم التسامح والتعايش السلِّمي الذي اصبح اليوم ليس غريبا في المنظور الإسلامي ، بل تعتبر مرتكزات ومبادئ جاء بها الإسلام ، من خلال الدعوة إلى التسامح ونبذ الخلافات والفرقة ، بل تعتبر واعتبرها ضرورة اجتماعية وسبيلا لضبط الاختلافات وٕادارتها إلى درجة أن المسلم أصبح ملزما بمقتضيات التسامح والعدالة ، حيث انعكس ذلك على منظومته الأخلاقية والسلوكية وبرزت في مفاهيم الرفق ، والإيثار، والعفو، والإحسان، والقول الحسن ، والألفة والأمانة .
فالأسرة بقيمها الديمقراطية تنتج جيًلا ديمقراطياً متسلحاً بالقيم التي ترفض التسلط والاستبداد وتعزز مفاهيم الخير والأمن وتتمسك بقيم العدالة وتنادي بحقوق الإنسان وفق القنوات السليمة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتعمل على احترام الحقوق والواجبات وتؤمن بالتعايش السلمي واحترام الأقليات ونبذ العدوانية. وحل الخلافات بالحوار والمناقشة وبمعنى آخر فالتربية هي صانعة الديمقراطية والديمقراطيين فهي أساس الحياة ونبذ التعصب وهي نواة التربية المجتمعية لأنها قلب الديمقراطية في المجتمع ( نذر،2001،ص88)
بل أن تلك التربية التي تعتمد على حرية الرأي والديمقراطية تربي لدى الفرد القدرة على إبداء وجهات نظره وامتلاك الوعي والإدراك ضد بعض صور الإرهاب كاختطاف الطائرات أو التفجيرات والاغتيالات وإيهام أفراد أن من يقوم بمثل تلك الأعمال هو شهيد في سبيل الله. وبالتالي يستطيع الفرد الابتعاد عن تلك الجماعات لأنه تكون لديه مانع دفاعي وهو الحرية والكرامة التي ساعدت التربية الأسرية ووسائطها في التكوين السليم الواعي لها.
توصيات :
أولاً : إن الإسلام دين ، وعبادات ومعاملات ، وشعائر وشرائع ، وهو مادة وروح ، وهو منهج حياة ، تتفاعل فيه القيم الإيمانية والقيم الأخلاقية لتفرز سلوكيات سوية للمستهلك نحو اتخاذ القرار الرشيد فى جميع أموره .
ثانياً : هناك أثر فعال للتربية دفعت الانسان نحو اتخاذ القرار الرشيد الذى يحقق له مقاصد الشريعة الإسلامية والتى تتمثل فى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، كما يجب التحذير من المفاهيم المستوردة والتى تتعارض مع قيم الإسلام لا سيما في ظل العولمة .
ثالثاً : إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام . وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية، والسلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، وأصبحت جزءاً من كيانهم، وهو غاية الإسلام في الأرض .
رابعاً : إن السلام هو أمنية ورغبة أكيدة يتمناها كل إنسان يعيش على هذه الارض، فالسلام يشمل أمور المسلمين في جميع مناحي الحياة ويشمل الأفراد والمجتمعات والشعوب والقبائل، فإن وجد السلام انتفت الحروب والضغائن بين الناس، وعمت الراحة والطمأنينة والحريّة والمحبة والمودة بين الشعوب.
خامساً : هناك دور وأثر واضح للتربية ، اذ تساهم في تحقيق السلام العالمي وتعزيز التعايش السلمي وإشاعة التراحم بين الناس ونبذ العنف والتطرف بكل صوره ومظاهره، وكذلك في نشر ثقافة الحوار الهادف بين أتباع الأديان والثقافات لمواجهة المشكلات وتحقيق السلام بين مكونات المجتمعات الإنسانية وتعزيز جهود المؤسسات الدينية والثقافية في ذلك.
سادساً : تعد التربية شأناً عظيماً ، فما كان أمراً شخصياً ولا هدفاً قومياً او وطنياً بل كان عالمياً وشمولياً، اذ شجعت على السلام الذي هو الأصل الذي يجب أن يسود العلاقات بين الناس جميعاً، فالمولى عز وجل عندما خلق البشر لم يخلقهم ليتعادوا أو يتناحروا ويستعبد بعضهم بعضاً، وإنما خلقهم ليتعارفوا ويتآلفوا ويعين بعضهم بعضاً.
سابعاً : تعد التربية ضرورة حضارية باعتبارها ضرورة لكل مناحي الحياة البشرية ابتداء من الفرد وانتهاءً بالعالم أجمع فبه يتأسس ويتطور المجتمع.
وقد حان الوقت لنقف على عتبات المجتمع الدولي ونقود أجيالنا إلى لغة الحوار ونصرخ بصوت عال لا للحروب لا للإرهاب لا للقتل لا للدمار ولا للعنف.
وفي ضوء ذلك ينبغي الأخذ بالجوانب الآتية :
- التأكيد على أن تعمل جميع المؤسسات لمواجهة التحديات الفكرية بالنسبة لكل من الحاضر والمستقبل.
- ضرورة تطوير نظم وأساليب تربوية بصفة مستمرة في ضوء المتغيرات والتطورات المعاصرة، بما يتناسب واحتياجات المجتمع .
- يجب على الأسرة فى ظل الظروف الراهنة العمل على غرس القيم الدينية والخلقية فى نفوس الأبناء وإكسابهم القيم الأخلاقية والاتجاهات والأنماط السلوكية المحمودة التى يمكن عن طريقها مواجهة الغزو الفكرى وحملات التشكيك التى تستهدف القيم والمعتقدات والمقدسات الإسلامية.
- أن تعمل كلا من المدارس والجامعات على تكوين الاتجاهات الصالحة والقيم البناءة والهادفة فى نفوس الطلاب من خلال المناهج الدراسية وأسلوب التدريس، وإحلالها محل الاتجاهات العدائية نحو المجتمع ونحو الآخرين حتى يمكن تغيير نظرتهم إلى ذاتهم وإلى الآخرين.
- تضافر جهود المؤسسات كافة في الحفاظ على وحدة الصف العراقي لدى أفراد المجتمع.
- ضرورة تأصيل المفاهيم التربوية المعاصرة، والتدقيق في المفاهيم التربوية من أجل تجلية معانيها بالدراسة والبحث.
- الاعتماد على الجانب العملي التطبيقي لدلالات التربية في المناهج الدراسية وخاصة في كتب التربية الإسلامية .
- تضافر جهود المؤسسات التربوية في الحفاظ على التربية السليمة لدى أفراد المجتمع.
- تعزيز دور الأسرة التوجيهي والرقابي للحفاظ على فطرة أبنائهم .
- الاهتمام بتوجيه المتعلمين إلى ضرورة الحفاظ على قيمهم والتمسك بدينهم .
- تعزيز مفهوم التربية لدى المتعلمين ، واختيار الأساليب التربوية المناسبة للحفاظ عليها .
- إيجاد إعلام إسلامي يحافظ على تربية أبناء المجتمع .
المقترحات :
- دراسة الآثار بعيدة المدى التى يتركها الحرمان على الشباب مستقبلا وسلوكهم خارج المؤسسات .
- دراسة المشكلات السلوكية منفردة حسب أهميتها وأثرها على الطفل وكيفية التعامل معها.
- دراسة أساليب التربية داخل المؤسسات وأفضلها والعمل على تطوير بعض الأساليب .
- إجراء دراسة للتعرف على أبعاد ظاهرة الضغط النفسي .
المصــادر
- القرآن الكريم
- أبو دف، محمود خليل . مقدمة في التربية الإسلامية ،غزة ، فلسطين ، 2002.
- التل، أحمد، الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، دار الأمل، عمان، 1998م.
- الحسين، أسماء عبد العزيز : المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعلاج النفسي. الرياض: دار عالم الكتب 2002.
- الخطيب، إبراهيم ياسين ، الزيادي، أحمد محمد . صورة الطفو لة في التربية الإسلامية، الدار العلمية، عمان، الأردن، 2000 .
- الخميسي، السيد سلامة . التربية والمدرسة والمعلم- قراءة اجتماعية ثقافية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2000 .
- دعبس، محمد يسري. الإرهاب ، الإسكندرية، وكالة البنا للنشر والتوزيع، 1994 .
- راجح، أحمد عزت . أصول علم النفس. الإسكندرية: دار المعارف. 1985 .
- سرحان، منير المرسي: في اجتماعيات التربية، ط 3، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1981 .
- الظاهري، خالد بن صالح بن ناهض. دور التربية الإسلامية في الإرهاب. رسالة دكتوراه منشورة. الرياض: دار عالم الكتب. 2002 .
- عفيفي، محمد الهادي . في أصول التربية الأصول الفلسفية في التربية ، مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة ،1996.
- عمر ،أحمد عطا. تربية الطفل في الإسلام ،دار الفكر ،عمان ،الأردن ، 2007 .
- العويني، محمد علي . الإعلام العربي والدولي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ،1984.
- العناني، حنان عبد الحميد . تربية الطفل في الإسلام ،دار صفاء، عمان، الأردن ،2001 .
- العياصرة ،وليد رفيق .التربية الإسلامية واستراتيجيات تدريسها وتطبيقاتها العملية ،دار المسيرة ،عمان،الأردن،2010 .
- القرضاوي، يوسف . الخصائص العامة للإسلام ،مؤسسة الرسالة، بيروت ، 1985 .
- قطب ، محمد . منهج التربية الإسلامية ، دار الشروق ، القاهرة ،1981 .
- اللويحق، عبد الرحمن بن معلا . مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر. الجزء الثاني. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1998 .
- محمد، محمد سيد . الغزو الثقافي والمجتمع العربي المعاصر ، مجلة الأزهر،الجزء الخامس، السنة السابعة والستون ،1984.
- مرسي، محمد عبد العليم. الطفل المسلم بين منافع التلفزيون ومضاره ، مكتبة العبيكان ،الرياض، 1987 .
- المرصفي ، محمد علي . في التربية الإسلامية -بحوث ودراسات ،مكتبة وهبة، القاهرة ، 1987 .
- منصور، سيد أحمد والشربيني، زكريا أحمد ، سلوك الإنسان بين الجريمة العدوان الإرهاب. القاهرة: دار الفكر العربي. 2003 .
- موريس، إريك . الإرهاب التهديد والرد عليه ترجمة الدكتور أحمد محمود القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991 .
- نزر ، فاطمة، التنشئة الديمقراطية كما يدركها الوالدان والأبناء في الأسرة الكويتية، الكويت، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد ( 29 ) ،2001 .
- الهندي ،صالح ذياب . صورة الطفولة في التربية الإسلامية ،ط 2،دار الفكر ،عمان،2000 .
- يالجن، مقداد . التربية الإسلامية ودورها في مكافحة الجريمة. مطابع الفرز دق التجارية، 1987 .
(2) سورة الأحزاب : 21