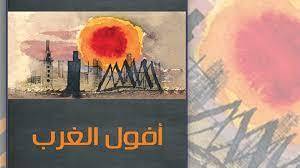حين نسأل: “من يقود التغيير؟” أو “أين الخطة التي ستصنع مستقبلاً أفضل؟”، فنحن في الحقيقة نبحث عن قائد خارجي، عن جهة ما تملك المال والإعلام واللوجستيات. لكن السؤال الأهم هو: ما جدوى كل هذه الأدوات إن لم يكن هناك استعداد اجتماعي داخلي لتلقيها وتوظيفها؟
التغيير لا يبدأ بقرارات فوقية، ولا ببيانات تُتلى من منصات رسمية. إنما يبدأ من البنية العميقة للعلاقات الاجتماعية، من القيم التي تحكم العائلة والمدرسة والشارع ومكان العمل. فالمجتمع الذي يفتقر إلى العدالة داخل أسرته، أو إلى الشفافية في مؤسساته الصغيرة، لا يمكن أن ينتج عدالة سياسية أو شفافية على مستوى الدولة.
المحرك الحقيقي للتغيير إذن ليس قائداً فرداً ولا طبقة سياسية جاهزة، بل هو إرادة جماعية تتجسد في سلوك يومي صغير: في التربية، في النقاش، في احترام الاختلاف، في التمسك بالعلم والمعرفة والفن كجزء من الحياة اليومية. هذه التفاصيل التي تبدو “ناعمة” وغير مرئية هي البنية التحتية لأي مشروع تغيير.
الخطة ليست غائبة، لكنها موزعة في الوعي الاجتماعي. حين يختار الناس أن يرفضوا الإقصاء، أن يعاملوا أبناءهم بحب، أن يفتحوا مدارس على النقد لا على الطاعة، وحين يصبح الفضاء العام مساحة للتعدد لا للتشهير—هنا تكون الخطة قد بدأت.
أما القيادة التي نحتاجها فهي ليست زعيماً عسكرياً أو خطيباً مفوهاً، بل شبكة من المربين والمثقفين والفاعلين الاجتماعيين الذين يرسخون ببطء ثقافة بديلة. هؤلاء لا يملكون جيوشاً ولا قصوراً، لكنهم يملكون القدرة على إنتاج وعي جديد، والوعي هو الاستثمار الأطول مدى.
القدرات المادية والإعلامية مهمة بلا شك، لكنها بلا معنى إذا لم يسبقها تغيير في الوعي والسلوك. المال قد يبني جسوراً، لكنه لا يبني ثقة. الإعلام قد يرفع شعارات، لكنه لا يصنع ضميراً. اللوجستيات قد تحرك الجموع، لكنها لا تزرع قيماً.
لهذا، حين نتحدث عن التغيير الحقيقي، فنحن نتحدث عن زمن طويل وصبر استراتيجي، عن تحولات هادئة تتراكم في الداخل قبل أن تظهر في الخارج. التغيير يبدأ عندما يتحول المجتمع من مستهلك للسلطة إلى منتج للمعنى.