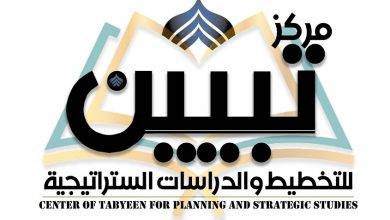لا تكاد كلمة في لغتنا العربية تثير التباساً مثل كلمة “الثقافة”. فهي في ظاهرها بديهية، لكنها ما إن تدخل ساحة النقاش حتى تنكشف كثيفة وغامضة، محمّلة بتصورات متباينة. وحين نضعها في مرآة الآخر، تزداد المفارقة وضوحاً: نحن نتحدث عن شيء، والأوروبيون يتحدثون عن شيء آخر تماماً. العربي، حين يقول “مثقف”، يقصد كاتباً أو أديباً أو صاحب مشروع فكري. أما الأوروبي فيرى الثقافة شبكة واسعة تضم كل ما يصوغ حياة الناس: عاداتهم اليومية، فنونهم الشعبية، أساطيرهم، أخلاقياتهم، وأنماط تفكيرهم. نحن نحصرها في النخبة، وهم يوسّعونها لتشمل المجتمع كله.
هذا الفرق ليس مسألة اصطلاحية، بل جذر سوء الفهم في حواراتنا. نحن نتجادل حول “أزمة الثقافة” بمعناها النخبوي، في حين ينظر علم الاجتماع الغربي إلى “أزمة الثقافة” بوصفها أزمة الذاكرة الجمعية: كيف يتفاعل مجتمع مع تاريخه، وكيف يوجّه ماضيه سلوكه اليومي ورؤيته للمستقبل. ولهذا يحق للأنثروبولوجي أن يتحدث عن ثقافة البدو أو الصيادين أو القرى النائية، من دون أن يرى في أميتهم عائقاً، بينما يميل القارئ العربي إلى إنكار الثقافة عنهم لمجرد أنهم لا يقرأون الكتب.
لقد ارتبطت الثقافة في الوعي العربي الحديث بالمعرفة المكتوبة. منذ لحظة النهضة، صار الكتاب رمز الخلاص من الجهل، وصار التعليم معيار الرقي. وهكذا تحوّل المثقف إلى حامل رسالة، يقرأ ويترجم ويكتب ويعلّم. ثم مع صعود الأيديولوجيات الكبرى، تضاعف الحمل: لم يعد المثقف مجرد قارئ أو معلّم، بل داعية يَعِد الناس بالخلاص الوطني والقومي والطبقي. لكنه في معظم الأحيان انتهى – كما لاحظ عبد الإله بلقزيز في نهاية الداعية – إلى خطاب متخم بالأساطير، وصراعات حادة تنتهي بالشتائم أو حتى بالعنف. لقد توهم المثقف العربي أنه منقذ، لكنه وجد نفسه عاجزاً عن تغيير القناعات، بارعاً فقط في تبديل الأقنعة.
أما الثقافة كما يفهمها الأوروبي فهي أوسع من ذلك بكثير. إنها ليست نخبوية، ولا تقاس بعدد الكتب المقروءة، بل هي ذاكرة حيّة تختزنها الجماعات. إنها ما نتوارثه بلا وعي: اللغة واللهجة، الأمثال والطقوس، طرق العمل والأكل واللباس، وحتى أسلوب الضحك والبكاء. إنها الماضي الذي يسكن الحاضر ويوجه المستقبل. ومن هذا المنظور يمكن فهم الفروق بين المجتمعات الزراعية والتجارية والصناعية: الأولى اعتادت إيقاع المواسم، فطُبع وعيها على الانتظار الطويل، بينما الثانية تربّت على المخاطرة اليومية، والثالثة اعتادت التغيير السريع. إن اختلاف التجربة التاريخية ينتج عقلاً جمعياً مختلفاً، وهذه هي الثقافة في جوهرها.
هنا يتضح أن الثقافة ليست وعياً بقدر ما هي ذاكرة. نحن نحملها قبل أن ندركها، ونتشرّبها من دون أن نشعر. الطفل يتلقاها من بيته، من لغته ولهجته، من إيماءات أمه، من القصص التي ترويها جدته، من الطقوس التي ترافق حياته اليومية. ومع مرور السنوات، يصير وعيه الفردي امتداداً لعقل جماعي سبق وجوده. كل تفصيلة في حياتنا اليومية – من طريقة الجلوس إلى أسلوب المزاح – هي تجسيد لهذه الذاكرة.
غير أن الوعي، حين ينهض، لا يكتفي باستعادة الذاكرة، بل يحاول أن يقرأها ويعيد ترتيبها. وهنا يُفترض أن يظهر دور المثقف الحقيقي: لا داعية يلوّح بالحلول الجاهزة، بل شاهد يصغي إلى ذاكرة الجماعة ويعكسها بلغة جديدة تساعدها على أن ترى نفسها. المثقف ليس نبياً ولا مخلّصاً، بل هو عين إضافية للمجتمع، يفتح بها أفقاً آخر. لكنه في فضائنا العربي ظل أسير خطاب تبشيري يتعالى على الجماعة بدل أن ينغرس فيها، فكان طبيعياً أن ينفصل عنها ويخسر قدرته على التأثير.
إن جوهر الإشكال يكمن في أننا خلطنا بين الثقافة والمعرفة. حسبنا أن التعليم وحده قادر على تغيير المجتمع، وأن نشر الكتب كفيل بإحداث النهضة. لكننا تجاهلنا أن الثقافة الجمعية لا تتبدل بالقرارات الفوقية، بل بتراكم بطيء من التجارب الحية. إن المجتمعات التي عانت طويلاً من القمع، مثلاً، تُطوّر ثقافة تقوم على الخوف والحذر، ولا تُقنعها الشعارات بسهولة. والانتقال من هذه الثقافة إلى ثقافة أكثر ثقة بالمستقبل يحتاج إلى زمن وتجارب، لا إلى خطب ومواعظ.
بهذا المعنى، تصبح الثقافة بين الذاكرة والوعي. الذاكرة ترسّب ما ورثناه من الماضي، والوعي يحاول أن يضيء هذه الترسبات ويعيد صياغتها. وإذا أُغفل أحد الطرفين اختل التوازن: فالمجتمع الذي يعيش بذاكرته وحدها يبقى أسير الماضي، والمجتمع الذي يكتفي بوعيه النظري يصبح غريباً عن ذاته. والمثقف مطالب بأن يوازن بين الاثنين، أن يصغي إلى ما هو مترسخ في لاوعي الجماعة، ثم يقدمه في صورة نقدية تُعينها على تجديد ذاتها.
إن إعادة التفكير في الثقافة بوصفها ذاكرة جمعية لا تُقصي أحداً، خطوة أولى لفهم أنفسنا. فالمجتمع ليس كتلة جاهلة تنتظر المثقف ليقودها، بل هو حامل لتجارب عميقة لا يمكن القفز فوقها. والمثقف ليس مبشراً بالخلاص، بل مشارك في قراءة هذه التجارب، وفي تحويلها إلى وعي جديد. هكذا فقط يمكن للثقافة أن تكون جسراً بين الماضي والحاضر، بين ما ورثناه وما نصبو إليه.
إنها ليست ترفاً فكرياً ولا سلعة نخبوية، بل هي نحن. هي الضحكة التي نتوارثها، اللهجة التي نتحدث بها حين نغضب أو نفرح، الأمثال التي نكررها كأنها بديهة. هي الذاكرة التي تحكمنا من حيث لا ندري، والوعي الذي يحاول أن يتحرر منها من دون أن يقطع جذوره. الثقافة بين الذاكرة والوعي ليست موضوعاً للنخبة وحدها، بل هي سؤال المجتمع بأسره.