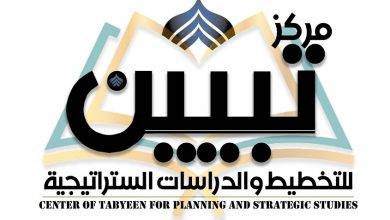في التاريخ السياسي العراقي الحديث، تتكرر الحكاية بأشكال مختلفة ولكن بجوهر واحد: قوى تدخل معترك السياسة محمولة على شعارات سامية وأحلام كبيرة، لكنها ما إن تقترب من السلطة حتى تتكشف هشاشة البنية الفكرية التي تحملها، وضعف ثقافة الدولة في مشروعها. هكذا وجدت الحركات الإسلامية الشيعية نفسها بعد عقود من المعارضة والسجون والمنفى، حين انتقلت فجأة إلى قلب الحكم، لكنها حملت معها ذاكرة المظلومية أكثر مما حملت أدوات البناء.
التجربة بدأت من إيمان ديني صادق، قائم على التديّن الفردي، قبل أن يتحول إلى مشروع سياسي يرفع شعار الحاكمية ويعدّ الإسلام نظاماً شاملًا للحياة. غير أن هذا الانتقال لم يكن وليد تراكم فكري أو برامج عملية لإدارة الدولة، بل كان اندفاعاً عاطفياً وتعبوياً، يقوم على الإيمان بأن إقامة الدولة غاية مطلقة، بصرف النظر عن الطريق إليها. ومع مرور الوقت، تحولت هذه القناعة إلى أداة اختزال للدين في السياسة، ثم أداة اختزال للسياسة في الصراع على السلطة.
حين وجد الإسلاميون أنفسهم في المنفى، كانوا يظنون أن سقوط النظام الحاكم مسألة وقت، وأن الحرب الإقليمية الكبرى ستكون هي الطريق لعودتهم. لكن الحرب انتهت ولم يسقط النظام، فتبددت الأوهام، وبدأت مرحلة التيه. هذا التيه لم يكن فقط تيهاً جغرافياً في المنافي، بل كان تيهاً فكرياً أيضاً: فبدل أن ينشغلوا ببناء ثقافة سياسية جديدة قادرة على تصور دولة وطنية تتسع للجميع، ظلوا أسرى الانتظار الطويل، وأسرى ذاكرة الألم، وأسرى التناحر فيما بينهم، حتى غابت البوصلة.
وحين جاءت لحظة السقوط المفاجئ للنظام، لم تكن القوى المعارضة تحمل مشروعاً وطنياً جامعاً، بل كانت محمولة على رياح الخارج، تدخل بغداد مثقلة بعقود من الغربة والتشظي. دخلت بذاكرة المظلومية، لكنها لم تمتلك تصور العدالة. دخلت بأحلام الحاكمية، لكنها لم تعرف معنى المواطنة. دخلت بشعارات الإسلام، لكنها لم تُحسن تحويل القيم إلى مؤسسات. وهكذا تحولت السلطة إلى غنيمة، وصار الحكم ساحة لتكريس الانقسام بدل تجاوزه.
المفارقة أن المظلومية لم تتحول إلى عدل، بل تحولت إلى ظلم جديد. فالذين كانوا يرفعون الدعاء لرفع الظلم عنهم، وجدوا أنفسهم وقد أعادوا إنتاجه بأشكال أخرى، حتى صار الفساد والتمييز والإقصاء ممارسات يومية في ظل حكمهم. وكأن التاريخ يسخر من أبنائه: فمن كان يتمنى أن يعيش يوماً في سلطة عادلة، وجد نفسه شريكاً في سلطة جائرة.
هنا يطرح السؤال الجوهري: لماذا تتكرر هذه الحلقة المفرغة؟ السبب الأعمق لا يكمن في شدة القمع السابق، ولا في حجم التدخل الخارجي اللاحق، بل في غياب ثقافة بناء الدولة نفسها. فالدولة ليست شعارات ولا محاصصات، بل هي منظومة قيم ومؤسسات، تتطلب وعياً وطنياً جامعاً يعلو فوق الهويات الضيقة. وحين تكون الثقافة السياسية قائمة على الانقسام والولاءات المذهبية أو الحزبية، فإن النتيجة الطبيعية أن تنهار أي تجربة حكم أمام أول اختبار.
المشكلة أن التجربة لم تُختبر فقط بالسياسة، بل بالدين ذاته. فحين يصبح الدين أداة للسلطة، تتحول القيم الكبرى إلى شعارات فارغة، ويتضخم “الأنا” الفردي والحزبي على حساب “التوحيد” الذي يعني الانفتاح على الله والعدل بين الناس. وهكذا انحرفت البوصلة: من دعوة إلى الله إلى دعوة إلى الذات، من مجتمع رباني إلى مجتمع ممزق بالأنانيات، من تضحية في السجون إلى تسابق على المناصب.
لقد كان ممكناً أن تتحول التجربة إلى فرصة تاريخية لبناء عراق جديد، ينقل المظلومية إلى مشروع وطني، ويجعل من الدين قوة أخلاقية حامية للعدالة، لا أداة لتقاسم الغنائم. لكن الذي حدث أن الفرصة ضاعت، وأن العقد الاجتماعي الذي وُضع بعد التغيير كان قائمًا على المحاصصة والتفتيت، فكان من الطبيعي أن يولد الفساد والانقسام من رحمه.
اليوم، بعد عقدين من ذلك التحول، تبدو النتيجة أكثر وضوحاً: لا المظلومية انتهت، ولا الدولة بُنيت. بل إن الظلم تعمق بشكل آخر، والهوية الوطنية ازدادت تشظياً، والدين الذي كان يمكن أن يكون جسرًا للوحدة أصبح في أحيان كثيرة جداراً للفصل. والسبب، مرة أخرى، هو غياب ثقافة الدولة.
إن الخروج من هذه الدائرة لا يكون بالعودة إلى شعارات الماضي، ولا بالرهان على الخارج، وإنما ببناء وعي جديد يضع الدولة في قلب المشروع السياسي، لا كغنيمة طائفية، بل كبيت جامع لكل المواطنين. فالدين يمكن أن يمد السياسة بالقيم الروحية والأخلاقية، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الدولة. والمظلومية يمكن أن تكون وقوداً للعدل، لكنها إذا تحولت إلى هوية دائمة فلن تلد إلا مظلومية جديدة.